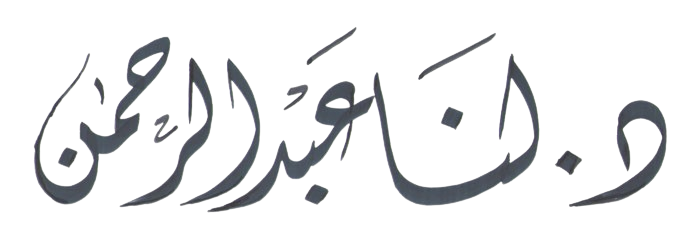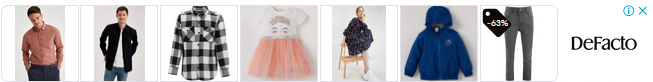لنا عبد الرحمن تتشبّث بـ”ذاكرة الوصال”
تأمّل في متاهة الحياة وشغف الإبداع

في كتابها “ذاكرة الوصال: سيرة متأملة في الحياة”، تستدعي لنا عبد الرحمن ما استقرَّ في وجدانها وعقلها من أعمال أدبية وفنية، من ثقافات مختلفة، لتتأمله مقترناً بتجاربها الإبداعية وسيرتها الذاتية، بين لبنان حيث نشأت، ومصر حيث تقيم، عبر ما يسمح به “الوصال” المقيد بعزلة قد تكون إجبارية، وقد تكون أيضاً اختيارية.
“ربَّ ضارة نافعة”. ربما يرد هذا المثل في ذهن القارئ وهو يتصفح الكتاب الصادر عن ” دار العين – القاهرة”. والضارة هنا تتمثل في وباء كورونا تحديداً الذي تسبب انتشاره خلال عامي 2020 و2021، في إجراءات احترازية فرضت على الناس في أنحاء مختلفة من العالم ما يشبه العزلة، ومن ثم تعذّر عليهم “الوصال”، الذي يعني هنا الاتصال بمن أو بما نحب، على نحو واقعي حميم، وبالتالي لا يكون ثمة مفر من الاتكاء على الذاكرة للتحايل على حنين جارف للسفر ولمس البشر والأشياء من دون خوف. وهو المعنى الحاضر في الذاكرة الجمعية عبر تجليات إبداعية مختلفة منها الأغاني، وهنا يرد في البال مثلاً قول أم كلثوم في إحدى أغانيها: “أفضل أعد الليالي وأقول وصالك قريب”، وأغنية “شفت حبيبي” لمحمد عبد المطلب التي يقول فيها: “الوصْل جميل حلو يا محلاه”.
هكذا كانت هذه العزلة مناسبة للتأمل بالنسبة إلى كثير من المبدعين، ومنهم لنا عبد الرحمن التي جمعت حصاد تأملاتها خلال عزلةٍ ما في كتابها هذا. تقول في أحد فصول كتابها الذي يقدم جزءاً من سيرتها الذاتية، خصوصاً في جوانبها المتعلقة بالإبداع الأدبي: “لا يوجد شيء خارج غرفتي، هذا ما اكتشفته خلال محنة كورونا، ما الذي يمكن أن أجده خارج غرفة مكتبي أكثر إمتاعاً من كتبي وأوراقي وروايات بالعربية والفرنسية والانكليزية، و”سيديهات” الموسيقى، وجهاز الكومبيوتر الذي أكتب عليه؟ شيء واحد أتحسّر على غيابه هو السفر وعجزي عن متابعة اكتشافاتي” (ص 161). هنا يتجلى ما تقصده عبد الرحمن بالوصال المتاح في أثناء العزلة، سواء أكانت إجبارية أم اختيارية.
النهر والبحر
المقدمة عنوانها “كل ما يمكننا تذكره” :”مثل ماء النهر الذي يصب في البحر ثم يعود مرة أخرى إلى بيته الأول، جاءت الحكايات هنا”. تتداخل هنا سمات المبدعة مع سمات الناقدة: “مثل ذاكرة الأيام المتشابكة، تلاحقت الكلمات، لتكون حرة ماضية بلهاث خلف الفضول المهيمن للحواس، الذي أدى إلى الكتابة والبحث في متاهة الحياة، التي تقود كلّ طرقة فيها إلى أخرى، في تجاورات تحكي عن الأسباب والنتائج في آن واحد؛ لأن الطبيعة المتغيرة تتجلى في كل ما يحيط بنا، في رائحة التفاح والغاردينيا، وفي لحن بعيد يطرق أسماعنا فجأة، وفي قصة قصيرة نتذكرها من أيام الصبا، وفي ارتعاشة ورقة الشجر في الشتاء، وفي قضمة من كعكة الطفولة التي صنعتها الجدة بمحبة” (ص9 )

الكاتبة لنا عبد الرحمن
يضم الكتاب أربعة أقسام: “مائدة الحواس”، “بيت بيوت”، “أذن تعشق، عين تسمع، وجوه وأصوات”، و”عن الكتابة والحب”. في أحد فصول القسم الأخير تستدعي عبد الرحمن الكاتبة إيزابيل الليندي لتتذكر أنها كانت في العشرين من عمرها عندما قرأت روايتها “ابنة الحظ”؛ “ومنذ ذلك الوقت ظللت حريصة على متابعة جميع إصداراتها”، ملاحظة أنها خلال العزلة المفروضة بسبب وباء كورونا، “كانت تشارك في العديد من الأمسيات الافتراضية وحلقات النقاش وقدّمت أيضاً محاضرات حول الكتابة الإبداعية”. ومن هنا اعتبرتها عبد الرحمن مثالاً يحتذى، فهي استثمرت العزلة الإجبارية كذلك لتنجز كتابها “روح المرأة”، و”تطعم كلابها وتمارس تمارينها وتهتم بزوجها”، على رغم أنها كانت آنذاك في الثالثة والثمانين من عمرها.
الكتابة والطبخ
ومن تأملاتها في حياة الليندي وإبداعها، تنتقل عبد الرحمن إلى مفهومها الشخصي للكتابة: “لا أتجاوب مع الصوت الهامس الحاضّ على الكتابة، إلا عندما يشتد ويتحول إلى صراخ في رأسي”. وتقول إنها عندما بدأت كتابة رواية “أغنية لمارغريت”، “كانت صورة مارغريت دوراس مع رفيقها يان أندريا، تعيش معي طوال اليوم أثناء الكتابة، صورة تتقاطع مع حكاية زينب خلال الحرب”. وتضيف صاحبة كتاب “الروائي والمخيلة والسرد” أنها عند كتابة رواية “ثلج القاهرة”؛ “كانت تنتابني ارتعاشات تدفعني إلى النقر سريعاً على الكومبيوتر، وأنا أكتب عن الأميرة نورهان، الروح العتيقة الآتية من بعيد لتحكي قصتها” (ص 277). لكن علينا الاعتراف – تقول عبد الرحمن – بأنه في “الكتابة وحدها، الخيالات جزء من الحقيقة، والحقيقة ليست إلّا خيالات… لذا استمرّ في الكتابة”.
وفي موضع آخر من متن تأملاتها الذاتية لاحظت عبد الرحمن أن فعل الطهو يشكل حالة إبداعية تحتاج إلى مخيلة توّاقة إلى التجريب، عبر دمج مذاقات جديدة، وتجاور أنواع وألوان من الأطعمة والوصفات التي تبدو غريبة للوهلة الأولى، ثم تصير مألوفة في حال نالت إعجاب الذواقة” (ص68). وهي هنا استدعت العديد من برامج الطبخ التلفزيونية، ورواية “غرفة تخص المرء وحده” لفرجينيا وولف، ومشهداً من فيلم “الساعات” الذي يتناول حياة الكاتبة الإنكليزية نفسها، وكتاب “أفروديت” لإيزابيل الليندي، وكتاب “مذاق الزعتر” لمجموعة من الباحثين في ثقافات الطهو في الشرق الأوسط، ورواية “بيوغرافيا الجوع” للكاتبة البلجيكية إميلي نوثومب، ورواية “الجوع” للمصري محمد البساطي. وما تخلص إليه في تأملها للطهو باعتباره “الفن الثامن بعد السينما”: “أظن أننا كشعوب عربية ما زلنا في حاجة إلى تعلّم لغة الحواس، إنها اللغة التي تمكّن الإنسان من الاستمتاع بكمية قليلة من الطعام، لأنها تنبهه إلى يقظة حواس روحه مع كل لقمة ومع كل رشفة قهوة”.
الفنجان المكسور
ومن سنوات صباها تتذكر عبد الرحمن جارة؛ “كانت بالغة الظرف والفطنة، تستطيع التخلص من أيّ حرج اجتماعي بسهولة. من ذلك مثلاً حين يتجاوز عدد زائراتها عدد الفناجين المتماثلة لديها، كانت تضع في وسط صينية التقديم الفنجان المختلف، وتزعم أنه فنجان الحظ، وأنها ستقرأ الطالع لمن يكون من نصيبها. وهكذا كانت تحمل الفتيات والنسوة على التسابق لنيل “فنجان الهنا”؛ لاسيّما من كانت منهنّ تنتظر محبوباً شارداً، أو أملاً ضائعاً أو ترجو الولد، ولأنّ لكلّ منهنّ حكاية معلومة وآمالاً مشتهاة، يتمّ تكثيفها كلّها بين يدي قارئة الفنجان المختلف، سرعان ما تنتشر النبوءات الخاصة بالضيفة المحظوظة في أرجاء الغرفة، وتصبح محور اللقاء وتأسف بقية الزائرات لأنّ الفنجان لم يكن من نصيبهنّ”. وتستدعي ذاكرة الوصال هنا أغنية “دارت القهوة” التي غنتها أميمة خليل وتتحدث عن الفتاة التي تتشاءم من “الفنجان المكسور” الذي وصل إلى يدها، بما أنّه إشارة للحبيب الغائب، والمستبعد أن يعود قريباً” (ص 88).
تقول المتأمّلة: “ولأني أنتمي إلى البشر الذين لديهم هواية شراء الفناجين من كل الأماكن، وتقديمها كهدايا أيضاً، فإنّ رفوفي تتجاور فيها إحدى نساء الحرملك القادمة من “توب كابي” في إسطنبول، مع فناجين عليها رسم بوذا وجبال الهملايا، مع أخرى عليها برج إيفل، وساعة لندن، تلقيت ذات مرة هدية من صديقة، فنجان قهوة صغيراً من متحف كليمت، أُعِدّه ضمن أحبّ مقتنياتي من الفناجين، بسبب محبتي لصاحبته، ولأنّ عليه رسم لوحة “القبلة” لكليمت. هذا الفنجان الصغير ظلّ موضع تأمّل، من دون أن يحتوي يوما أيّ سائل شفاف”.
أحزان مارلين مونرو
وفي أحد فصول القسم الثالث من الكتاب، تتأمل لنا عبد الرحمن “أحزان مارلين مونرو ومطبخها”، ملاحظة أنه إلى جانب الطبخ ثمة فعل آخر انشغلت به الممثلة الأميركية الراحلة، وهو الكتابة، “لكنه لم يأخذ من حياتها الحيّز الذي يسمح بالاستغراق فيه، إلى حدّ الانسلاخ عن الحياة الخارجية” (ص 209)
وهنا يحضر كتاب “شذرات” الذي يضمّ رسائل مونرو وخواطرها المبعثرة وقصائد ، جاء في إحداها: “وحيدة، إني وحيدة دائماً، مهما كان الظرف / أيتها الأشجار الحلوة الحزينة / أتمنى لك نعمة الراحة / لكن عليك دائماً البقاء على حذر”. ويحضر كذلك كتاب “حياة وآراء الكلب ماف وصديقته مارلين مونرو” للكاتب أندرو أوجان، وفيلم “الأسوياء” الذي اعتبره النقاد أحد أكثر أفلام مونرو تفرّداً، وهو على أيّ حال كان فيلمها الأخير ولم يحظ بإقبال جماهيري. تقول لنا عبد الرحمن: “كانت مونرو تندهش من مقولة ريلكه: إنّ الجمال هو بداية الرعب”، تقول إنّها تشكّ في فهمها الكامل للعبارة، لكنّها تعجبها. ربما لأنها تقف على تماس مع هذا الوصف الذي ينطبق بشكل ما عليها. ففي وقت اعتبرت أيقونة للجمال والإغراء، فإنّ هذا كان يحاذي الرعب، ولم يجلب لها أيّ نوع من السعادة” (ص 213).
علي عطا – النهار اللبنانية