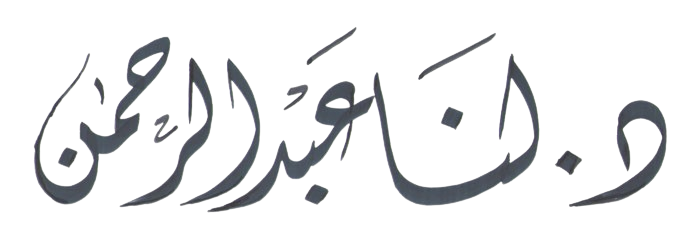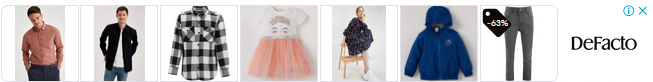موتى لا يكذبون

لم يتغير موقفي أبدًا من القصة القصيرة, مهما كانت الأسباب، ومنذ أن عرفت قراءة الأدب لم يحدث أن شدتني مجموعة قصصية من رواية, وقد استغربت دومًا من موقف عباس محمود العقاد الذي رأى أن بيت شعر بعينه أفضل بالنسبة له من خمسين رواية, ورغم دهشتي فإنني لا ألومه بالمرة فهذه ذائقته الأدبية والثقافة، ورغم انبهاري الشديد ببعض ما كتبه جي دي موباسان من قصص قصيرة, إلا أن روايته “حياة” شدتني كثيرًا, وربما باستثناء تشيكوف فإنني أحببت روايات يوسف إدريس كثيرًا, وعندما تغيرت أذواقنا فإن الموقف تجاه القصص القصيرة لم يتغير, ومن هنا فقد كنت صاحب المقال الذي صدم الناس عام 1983 بعنوان “انتهى عصر القصة القصيرة” وكنت في بداية حياتي في مجال النشر, واكتسبت خصومات عديدة كان أصحابها هم أول من تفوق في كتابة الرواية حين كتبوها, وأعترف أنني كنت أضطر إلى قراءة بعض المجموعات حتى لا أكون في مؤخرة مسيرة المعرفة, وأنا أتابع عصر ازدهار الرواية كما تنبأ مقال نشرته في يونيه من العام المذكور في الصفحة الأدبية بجريدة الأهرام, وأيضًا في مجلة الهلال.
وفي الفترة الأخيرة, أسرتني الكاتبة لنا عبد الرحمن بثقافتها, ورواياتها, ولكن بصري لم يسعفني على استكمال قراءة رواياتها كاملة, واضطررت إلى قراءة مجموعتها القصصية “الموتى لا يكذبون” بهدف الكتابة عنها, والغريب أنني وقعت في أزمة كبرى, فقد اضطررت إلى قراءة قصص المجموعة أكثر من مرة, وحاولت أن أتعامل مع النص على أنه رواية من فصول منفصلة, مثلما كنت أفعل مع أغلب ما قرأت من مجموعات، وقد قرأت المجموعة أكثر من مرة، وأبدأ من جديد, وأشعر بالحيرة تمسك بي بشدة، وعاودتني مشاعري القديمة, ولما كنت قد نويت للكاتبة أن أكتب عنها في محاولة للتعرف عليها باعتبارها من جيل يصغرني سنًّا، وفشلت في استيعاب النصوص المكتوبة، وانتابني الإحساس بالتعرف على المسافات الزمنية بين القصص, فلا شك أن أي مجموعة عبارة عن تجميع نصوص كتبها المؤلف في ظروف مختلفة من الصعب أن يكون بينها رابط واحد مشترك ووسط مشاعر الحيرة وجمال القصص, فإنني وجدت نفسي منحازًا بشدة للأقصوصة الأولى في المجموعة التي تحمل عنوان المجموعة نفسها, ووجدتني بلا سبب أنحاز اليها, حتى وإن كانت هناك أقاصيص أكثر منها جاذبية, وجمالًا, وبالفعل, فبالنسبة لي, فهي تشد الانتباه بعدد المرات التي تقرأها، ففي العادة أن النقاد يتناولون المجموعة القصصية باعتبار القصص تجمعها وحدة واحدة, أو سمات مشتركة, حتى وإن كانت مكتوبة في فترات زمنية متباينة, وذلك في الإطار الذي يجعل الناقد يرى النص من خلال محاولة لتلخيص الأقصوصة المقصودة تنطبق عليه سمات القصة القصيرة التقليدية من حيث المساحة الزمنية التي تدور فيها, وأيضًا عدد الأشخاص, ومنذ السطور الأولى نتعرف أننا أمام نص من نوع الفنتازيا الأرضية, والراوية تؤكد أن ما شهدته “فوق مستوى الخيال” ما يعني أن على القارئ أن يقبل الحكاية على أنها محض خيال جامح, قد يحدث, وربما لا, فالفتاة وهي تركب الأتوبيس تشاهد خالها الذي مات في العام الماضي يحدث هذا بشكل محدد وواضح في أول سطرين من الأقصوصة فيما يسمى براعة الاستهلال، أو الموجز في نشرة الأخبار قبل التعرف على روعة التفاصيل, وتأتي أهمية الأمر أن الراوية تستخدم عبارات محددة, واقعية تخلو من أي احتمال أنها تعبر عن الدهشة، فلا تلبث أن تقول أن الرجل لا يشبه خالها الذي مات منذ عام ولكنه هو بالفعل وفي الفقرة الثانية تبدأ التفصيلات حيت يتم وصفه من الخارج باعتباره أسمر البشرة, عيناه زيتيتان, أسود الشعر, وندبة في أعلى جبينه ما يؤكد أنه” هو”, و”يتواصل الفعل” فبعد أن انطلقت من السيارة تقترب منه, ويراها, وتصافحه ملتزمة الصمت, تتحرك الكلمات بسرعة مختصرة تعبر عن تطور الحدث, الذي وجدت الراوية فيه نفسها في خضم الموقف, ويتكلمان، فالخال الذي غيبه الموت هو الذي يبدأ بالكلام إلى الفتاة حين يسألها عن أحوال أمها ويحدثها بشكل دنيوي جدًّا عن سبب تهورها وقبولها الخطبة من عريسها..
هذا النوع من القص يمكن تأويله إلى العديد من الأنواع الأدبية المتعارف عليها.الراوية تتواجد في أماكن مألوفة بالنسبة إليها, ابتداء من الأتوبيس التي لمحت منه خالها إلى الشارع التي نزلت إليه, الأماكن التي ذهبت إليها تتحرى أن هناك رجلًا باسم مشابه يسكن في الشارع الخلفي لكنه أبدًا ليس خالها إلى أن تذهب للمنزل الذي كان يسكنه الخال الذي مات في العام الماضي, وهناك أدركت أن حياة ما تدب في المكان رغم رحيل صاحبه, وأما من ناحية الفانتازيا حيث تنمحي المسافات بين الزمن والأماكن والأشخاص, فإننا أمام نص فانتازي في المقام الأول باعتبار أن الموتى لا يعودون للتجسد, ولكن الخال هنا ظهر بجسده وبرائحة التبغ, وهو ليس مجرد خيال, فهو يتكلم, وينصح الفتاة ويعاتبها علي خطبتها.. كما تنتمي الأقصوصة إلى نوع الظواهر الخفية, أو إعادة التجسيد والعودة إلى الحياة, والتقمص, وندرك أن الخال لم يظهر عبثًا, بل إنه أراد توصيل رسالة حياتية إلى ابنة أخته, سواء كان قد مات أو لم يغادر الحياة بعد, فهو يبلغ ابنة أخته عن عدم رضاه عن خطبتها, وهي تحس من خلال الملموسات أن خالها موجود تنزع الدبلة عن أصابعها, كأنها تستجيب لمطالب الخال وتحذيراته.. هذه عبقرية الصياغة, فكافة الأشكال موجودة في النص, مع الدلالات والتبريرات, فلم يؤكد أحد أن الخال قد مات رغم رحيله, ولا يوجد ما يثبت أنه رحل, وتبدو العبقرية أن الكاتبة تصوغ عالمًا بديلًا موازيًّا لعالمها الواقعي بكافة ممتلكاته وفي هذا العالم يوجد الخال, لا تراه سوى الراوية, وهي تجد نفسها فيه لا تكتفي بالتلقي, بل أنها تسعى إلى البحث عن حقيقة مرتبطة بالواقع لكنها ليست فيه, فالنص يبلغنا عن عدم رضاء الخال عن الخطبة, دون أن نعرف السبب, والفتاة لا تهتم بما قاله الخال قدر التحقق أنه موجود في العالم الموازي, في حالة رحيله عن الواقع الذي ينتمي إليه الخطيب, كما لم نعرف مشاعر الفتاة, لكنها بدت كأنها تمتثل لما جاء من العالم البديل, وقيام الفتاة بنزع الدبلة يؤكد هذا.
في مثل هذا النوع من القص ليس عليك أبدًا أن تستفسر عن عقلانية الأسئلة بقدر ما تستسلم للسلوك الذي يفعله البعض, فهذه الظواهر التي قد ينكرها الكثيرون, قد تكون حقائق لدى آخرين, ومن هنا فإن القراء سيتبعونها بأكثر من طريقة حسب ما يمتلكه كل منهم من قدرات وإيمانات خاصة جدًّا, وعليه فإن الأقصوصة يمكنها أن تتحول بين يدي الكاتبة, أو أي مؤلف آخر إلى نص روائي طويل, لكن الكتابة المكثفة للأديبة لنا عبد الرحمن أحكمت حلقاتها فيم أرادت من نص.
بالطبع فإنني أوجزت, ولا أنكر أنني قرأت النص على أنه عمل روائي, أو يصلح ليكون نصًّا بالغ الدهشة, ويمكن ملاحظة ذلك في رواياتها المنشورة.
محمود قاسم